تؤدي اللغة وظيفة التواصل، ولكن الوظيفة الأهم من ذلك هي تشكيل الهوية، وتمثيل القانون الثقافي والفكري الذي تفرضه الجماعة على الفرد. فاللغة نظام عرفي اجتماعي يفرض ذاته على الأفراد؛ وإن كان كل فرد يستخدم اللغة في صورة الكلام أو الكتابة، إلا أنه لا يمكنه الخروج عن النظام العرفي للغة. فاللغة لا تنشأ إلا في المجتمع وبالتالي تكمن سلطة المجتمع في سلطة اللغة؛ إذْ تمثّل اللغة إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية التي تتحكم في أفراد المجتمع. وداخل مؤسسة اللغة توجد كل السلطات؛ الدينية، والسياسية، والفكرية، التي تتحكم في تفكير وسلوك أفراد المجتمع.

يقتضي كل كلام وجود لغة سابقة عليه في الوجود، وكل إنجاز تواصلي يستلزم قدرة سابقة. ولا يصح أن ننظر للغة باعتبارها نظام من العلامات اللغوية فقط؛ بل باعتبارها مجال تتصارع فيه قوى متعارضة على حد وصف جيل دولوز. فاللغة ليست تركيبا مستقرّا وإنما مؤسسة متغيرة تكمن في مضامينها احتمالات العنف. وتمارس ضد متحديثها الإكراه عبر سلطة موجودة في ذات اللغة. وتكتسب سلطة أخرى رمزية تأتي من المقام الاجتماعي للمتكلم، من ذلك الخطاب الذي يصدر من (السياسي، ورجل الدين، والمعلم، والأديب، والإعلامي …) وهذه السلطة يكتسبها الخطاب من خارج اللغة.
نعني بإكراه اللغة أن اللغة بسلطتها تحملنا على فعل ما لا نرضاه بأقوالنا أو تفكيرنا من خلالها. فنحن لا نختار لغتنا الأم أولا، ثم إننا لا نختار المفاهيم السائدة في ثقافتنا ثانيا. ومع هذا وذاك نحن لا نملك القدرة ولا الاختيار بالهروب من سلطان اللغة. والعنف يشمل الإكراه والاعتداء ومحاولة إقصاء الآخر بالقوة الفيزيائية التي يمهد لها غالبا بالخطاب اللغوي، أو القوة الرمزية التي تستخدم اللغة سلاحا فيها. وتكون اللغة هنا نظام شامل للسيطرة على الآخر داخل اللغة الواحدة، أو بسطوة لغة أخرى.
إن العنف لا يظهر عند البشر بشكل منفصل عن اللغة، إنه يسكن اللغة، فالإنسان يخلق العنف في المفردات ثم تنتقل في الواقع الفيزيائي. فالعنف الكامن داخل التاريخ لا وجود له بدون اللغة. إذْ اللغة سلاح للصراع، وميدان للحرب، وكلنا أسرى لدى اللغة. وتأتي خطورة إكراه اللغة في إقرارها لما هو قائم بالفعل أيّا كان ذلك الوضع الجماعي القائم. وتعكس اللغة المعاصرة النزاعات القديمة في تعبيرات من قبيل: “يا أحفاد ابن العلقمي” أو ” يا أحفاد بنو أمية”. وفي ذات الوقت اللغة هي المجال الذي تتحرك داخله النزاعات الراهنة على حد وصف جان لوسركل. وبمعنى آخر: اللغة هي التي تنقل لنا التعبيرات العنصرية البغيضة وفي ذات الوقت هي المجال الذي يتحرك فيه العنصريون. فالعنف اللغوي يُوقَع بواسطة الكلمات، ويحدث أيضا داخل الكلمات.

إن العنف الكامن في الإهانة اللغوية (مثلا). قد لا يعود إلى نبرة الصوت العالية؛ بل في سلسلة الألفاظ والحركات التعبيرية. على سبيل المثال حين يكتب على تويتر: ” في عرف بعض الأحباب: كيف يطيب لك الدفء، وفي بلاد كذا يموتون من البرد؟!”، فيرد الآخر بإهانة لغوية للكاتب: ” وفي عرف الكلاب؟”، فيرد الكاتب الإهانة اللغوية بإهانة لغوية أخرى؛ حتى لا يفقد كرامته في هذا الموقف اللغوي فيقول: ” أنت أبخص!”. وهذه الإهانة قد تبدو كلاما معسولا في ظاهرها، ولكن غرضها الأساسي إيقاع الألم الشديد.
إن كل سؤال هو تدخل قهري. وعندما يستخدم السؤال أداةً للسلطة فإنه يغدو سلاحا يخترق جسد الضحية. فالسائل أو المستنطق يعرف ماذا هناك وماذا سيجد، ولكنه يريد أن يلمس الإجابة ويخرجها للنور. وهو يحدث الألم في جسد الضحية مع كل سؤال. وهنا لا يكون هدف اللغة الإخبار أو التواصل؛ بل استخراج الإجابة، وإقامة علاقة تسلطية بين السائل والمسؤول؛ بفعل السؤال في ذاته. ويتساوى الأمر ما إذا كان السؤال شخصيا متكررا أو ملحّا، أو سؤالا رسميا في استنطاق رسمي. كلاهما يمثلان سلطة على الشخص المستنطق. وتبرز لنا اللغة بصورتها العنيفة، وتمثل مجالا لصراع العلاقات السلطوية؛ حين يتعمّد الأستاذ (مثلا) طرح أسئلة معقدة حتى يُظهر الطالب بمظهر الغبي؛ هنا لا يأتي إكراه اللغة بتحّكم مباشر من قِبل الأستاذ؛ وإنما من العرف اللغوي الذي يكون الاستاذ فيه سائلا والطالب مجيبا، والأستاذ آمرًا والطالب منفذا. أضف إلى ذلك القدرة اللغوية التي يمتلكها الأستاذ مقارنة بالطالب تجعله هو الطرف الأقوى الذي يمتلك سلطة الخطاب وسطوة اللغة. ولو امتلك الطالب من أدوات اللغة أكبر مما يمتلك الأستاذ؛ فإنه سيتفوق على أستاذه بالرغم من تفوّق الأستاذ في المكانة الاجتماعية. لأن الغلبة في المواقف الاجتماعية تكون دائما للمتمكن لغويا.
حين يستخدم العنف اللغة سلاحا يشهره الإنسان في وجه أخيه الإنسان. تمارس اللغة العنف ضد الإنسان باعتبارها تمثل سلطة المجتمع. ربما لا نستطيع التحكم في سلطة اللغة لأنها تنشأ بشكل اجتماعي وتحميها القوانين العرفية التي تتشكل بصورة تلقائية، لكننا نستطيع التحكم في استخدام اللغة أداة للعنف ضد الإنسان. وللوصول إلى آليات صناعة هذا العنف لابد من استنطاق اللغة وفحص الوعي الجمعي، وسبر أغوار المصطلحات والمفاهيم. فالعنف اللفظي من الأستاذ ضد الطالب جناية يصعب الإمساك بها وإثباتها؛ لكننا نستطيع معالجتها. لذلك لا بد من تحرير لغة العنف عند المعلمين، وتجريم الألفاظ أو أسلوب الخطاب الذي يوجه نحو الطالب بهدف إهانته أو عقابه. ومن جانب آخر تنقية الكلام في التعليم والإعلام من المضامين التي قد تزرع بذرة العنف ضد الآخر.
ليس هناك من سبيل آخر للتحرر من إكراه اللغة وعنفها دون ثورة معرفية تعيد تحرير ألفاظها ودلالاتها. فالكلمات ليست فقط الجانب المحسوس الذي نسمعه أو نراه مكتوبا فقط وإنما تحيل إلى محتوى. وبذلك تمتلك شكلا مزدوجا مكونا من الجانب المحسوس، ومن الجانب الآخر الذي يحتوي على المعنى أو الدلالة. فاللغة ليست أداة حيادية على حد تعبير جان سيركل بل هي مجموعة من الكلمات المشحونة بقوة بالرغبات والأحقاد في مقولة مباشرة مثل: (اقتلوهم)، أو في عنف التلميحات والتهديدات والاتهامات وذلك في إطلاق أوصاف وأسماء العدو على المخاطب، نحو: (يا عميل/ يا متصهين/ يا إرهابي….) التي تنبئ دائماً بالتحول إلى عنف جسدي، لأنها تصنف المُخَاطب مع الأعداء؛ وبالتالي تبيح للآخرين الاعتداء عليه. ولأن هذا النوع من العنف يُخلق داخل اللغة؛ فلا يمكننا أن نعالجه إلا داخل اللغة وبذات الأدوات اللغوية التي ساهمت في خلقه.


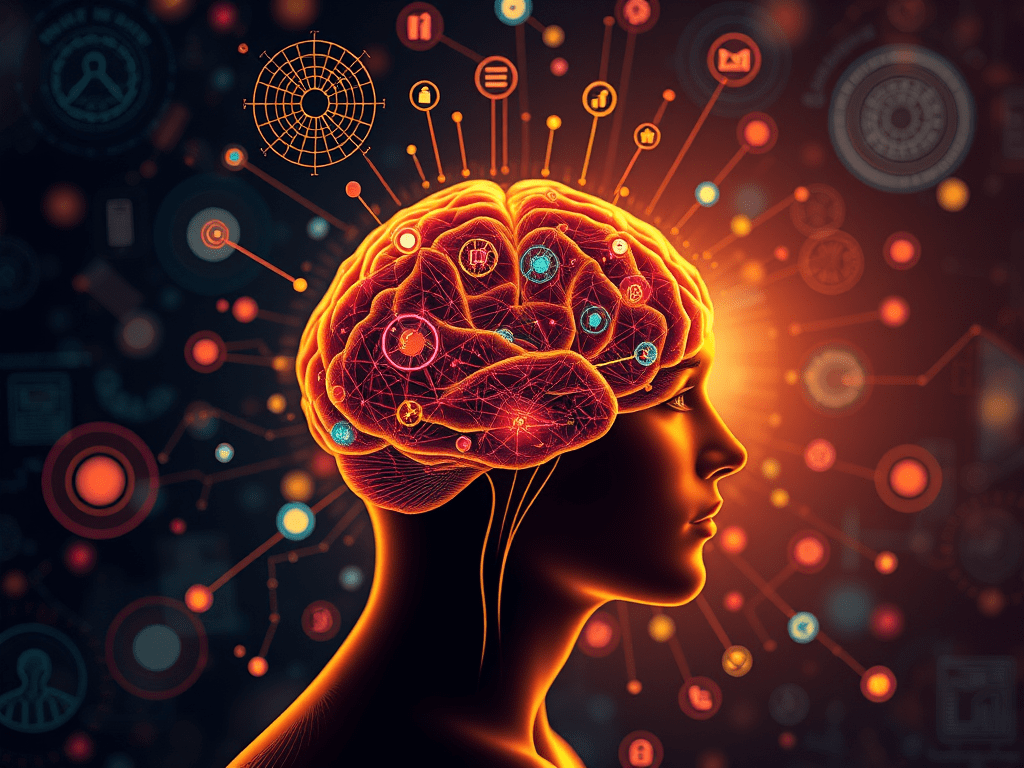


أضف تعليق