حين نتأمل حضور الزمن في اللغة، نجده حاضرًا في العمق؛ يتخلل الوعي الإنساني، ويعيد تشكيل علاقتنا بالمكان والجسد والذاكرة والمصير. فالزمن ليس مجرد نسق حسابي، ولا هو خط محايد من لحظات متعاقبة، بل تجربة حيوية مشبعة بالمعنى، متجذّرة في الشعور، وتُبنى لغويًا من خلال صور حسيّة وإدراكية متعددة.
لقد أطّرت اللسانيات الإدراكية هذا التصور حين ربطت بين اللغة والتجربة، واعتبرت أن المعنى يُبنى داخل الجسد والعالم، لا خارجهما. ومن خلال نظرية الاستعارة الإدراكية، نجد أن اللغة لا تصف الزمن، بل “تخلقه” إدراكيًا، عبر استعارات تستمد مادتها من الجسد والفضاء والحركة. فالإنسان لا يستطيع أن يدرك المفاهيم المجردة إلا من خلال إسقاط خبرته الحسية عليها، ولهذا تُبنى مفاهيم “الزمن”، و”الحياة” من خلال استعارات مأخوذة من مجالات محسوسة مثل “المكان”، و”الطريق”.

إن اللغة العربية، بوصفها حاملة لتجربة الإنسان في الزمان والمكان، تُقدّم ثراءً تصويريًّا دالًّا على هذا التفاعل العميق بين اللغة والزمن. فحين يقول العربي: “ترك الماضي خلفه”، أو “أمامه مستقبل واعد”، أو “قطع شوطًا من عمره”، فهو لا يستخدم تعبيرًا مجازيًا تزيينيًا، بل يكشف عن بنية إدراكية راسخة تجعل الزمن مرئيًا ومتحركًا، وتجعله طريقًا يُسلك، أو كائنًا يُشخّص، أو ثقلا يُحمل، أو مقدارًا يُقاس. هنا تصبح اللغة خريطة ذهنية للزمن، وتُحيلنا إلى تصورات لا ننتبه إليها عادة، لكنها تسكن طريقتنا في الفهم والتفكير.
فالماضي في الذهنية العربية غالبًا ما يتموضع خلف الذات، لأنه تجمّعٌ لما تمّت رؤيته ومعايشته، أما المستقبل فموضعه أمامنا، لأنه لم يُرَ بعد، ولكنه يُنتظَر. هذه العلاقة بين الرؤية والزمن تَظهر في تعبيرات كـ”الماضي المُشاهد”، و”المستقبل الغيبي”، وهو ما يلتقي مع ما توصلت إليه دراسات في لغات أخرى كالإيمارا والتي تظهر لنا ثقافة مختلفة ترى الزمن بصورة عكسية، ترى أن الماضي أمام الإنسان لأنه معلوم ومرئي، بينما المستقبل خلفه لأنه مجهول. وهذا يعيدنا إلى مركزية الجسد في بناء المفهوم الزمني: ما نراه بأعيننا هو ما يقع أمامنا، وما لا نراه خلفنا، وهكذا يُبنى الزمن، لا فقط كاتجاه، بل كمنظور إدراكي متمركز حول الذات.

وحين نُدقق في استعمالات اللغة اليومية، نرى الزمن وقد تحوّل إلى حيز مكاني: فنقول إن الحدث وقع “قبل العصر” أو “بعد الغروب”، أو أن الزمن “بين الأمس والغد”، أو أن الموعد “يقترب”، أو أن الأيام “تمضي”، وكأن الزمن سيلٌ جارٍ، أو فضاء نقطعه مشيًا. تُستعار حروف المكان لتحديد الأزمنة، فيصبح الزمن “فوقنا”، أو “وراءنا”، أو “في الطريق”، وتصبح الحياة “رحلة”، والطفولة “مرحلة عبرناها”، والشيخوخة “أفقًا أمامنا”. الزمن هنا ليس مفعولًا به، بل مجالٌ ندخله، ونحدده انطلاقًا من وجودنا الحسي.
ومن المدهش أن اللغة لا تكتفي بتحديد موقع الزمن، بل تمنحه صفات الكائنات الحيّة. فالزمن يغدر ويصبر ويهرب ويُرهق ويشفي ويقتل ويُداهم. إنه ليس موضوعًا جامدًا بل ذاتًا فاعلة. تقول العرب: “أرهقته السنون”، “خدعه الزمن”، “أحسن إليه الدهر”، “أخذته الأيام”، “هدّه مرور العمر”… وهذه الأفعال تُشخّص الزمن وتجعله فاعلًا في السرد الوجودي. وهو في ذلك يشبه الإنسان: يجيء ويذهب، يغلب ويُغلب. وهنا، لا تُستخدم اللغة للتزيين البلاغي، بل للتفاعل الإدراكي، فالعقل لا يكتفي بوصف الزمن، بل يعيد بنينه بوصفه طرفًا حيًّا في معادلة الحياة.

ولأن التجربة لا تُفهم إلا عبر الجسد، فإن اللغة تعطي للزمن أبعادًا تجسيدية. فالوقت “يثقل”، و”يضغط”، و”يتباطأ”، و”يتسارع”، و”ينفلت”، و”يضيع”. تُستعار مفاهيم الكتلة والحركة لتصوير الإحساس بالزمن، وكأن الزمن شيء مادي محسوس. نقول: “اللحظات ثقيلة”، “الانتظار طويل”، “الفرح يمرّ سريعًا”، “الموت يقترب”، “الأجل يزحف”، وكأن الزمن مادة نعيش داخلها ونتفاعل مع تضاريسها الحسية.
ومن جهة أخرى، يظهر الزمن في اللغة كمورد مقيّد يُستهلك ويُنظم ويُخطط له. نُقسمه إلى ساعات وأيام وشهور، ونضع له جداول ومواقيت، ونعبر عنه كمقدار: “وقت كافٍ”، “لا وقت لدينا”، “استغرق وقتًا طويلاً”، “أنجز المهمة في أقل من ساعة”. هنا يتحوّل الزمن إلى وحدة قياس، وإلى مساحة قابلة للإدارة، ويتقاطع مع مفاهيم الاقتصاد، والإنتاج، والكفاءة.
هذه الأبعاد جميعها – المكاني، التشخيصي، التجسيدي، والمقياسي – ليست منفصلة، بل متداخلة، تُشكّل البنية الذهنية التي نعيش بها الزمن ونفهمه بها. واللغة العربية، في تعبيراتها اليومية والأدبية، تُقدّم تمثيلًا غنيًا لهذه الأبعاد، وتُظهر كيف أن الزمن لا يوجد خارج اللغة، بل يُبنى فيها، ويتجلى من خلالها، ويكتسب شكله النهائي عبر الإدراك المجسد المتفاعل مع الثقافة والهوية.


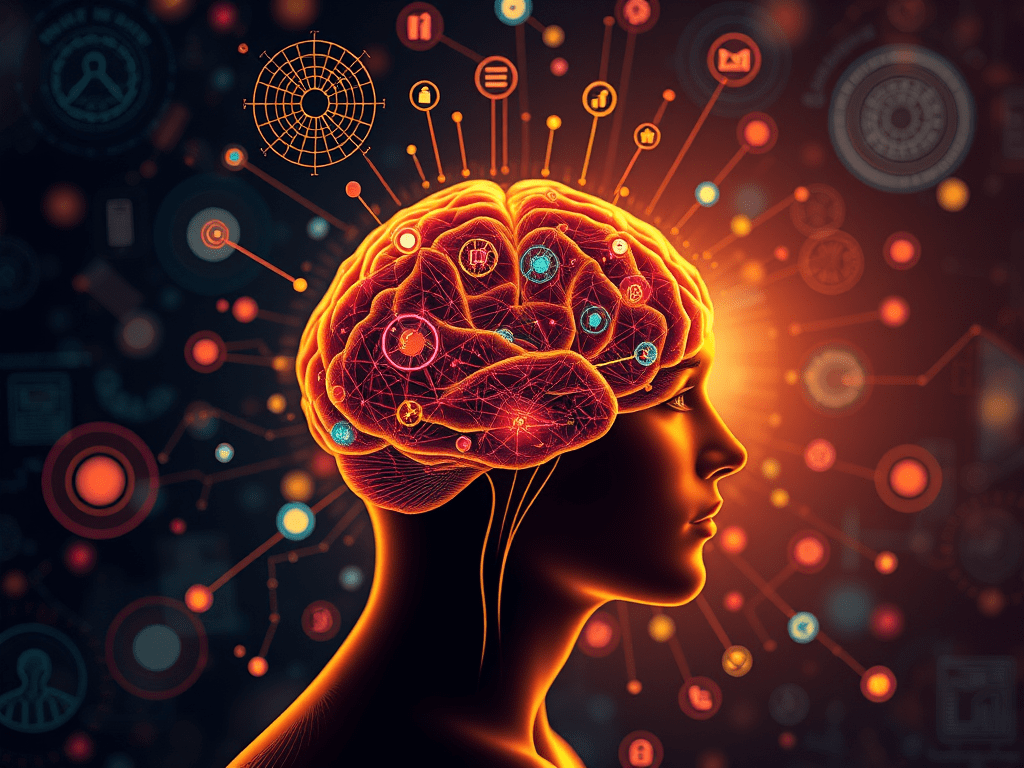

أضف تعليق